بداية لا أنكر أني شعرت بالغيرة من الكتاب، ليس وحسب لأنه ينتمي إلى الحقل الذي أحبه، إنما أيضاً لأنه يذكرني بمشاريعي التي لا تعرف طريقاً إلى الاكتمال فتبقى ملاحظات ومسودات. يتطرق الكتاب إلى فكرة غاية في الأهمية، خاصة في سياقنا المعاصر ونزاعاته. فكرة تبدو اليوم مربكة وربما غير مفهومة من العديد من الذين ينظرون إلى تاريخنا انطلاقاً من سياقنا المعاصر ونزاعاته والخطوط الحادة التي رسمها بين الأيديولوجيات والتيارات.
يتناول الكتاب الدور المحوري الذي لعبته النقشبندية في بناء الوعي القومي الكردي وقيادة الأكراد في انتفاضاتهم وثوراتهم، حيث صعدت النقشبندية إلى سدة قيادة المجتمع الكردي في سياق الاصلاحات العثمانية التي دمرت الإمارات الكردية وحكم الأمراء والمشايخ، هذا التدمير الذي ترافق مع انهيار ي المجتمع الكردي ومدنيته وتعميق تحوله إلى تجمعات عشائرية مترحلة، أو تحت هيمنة إقطاعية تعززت مع الإصلاح العثماني وما رافقه من ملكية الأراضي التي آلت إلى الأغوات. في لحظة الفراغ السياسي باندثار حكم الأمراء، وعدم وجود قيادة قومية-برجوازية لمجتمع تسوده الأمية والعشائرية وتضعف فيه المدنية، صعدت النقشبندية إلى سدة القيادة. في مقابل النقشبندية، كانت هناك أيضاً طريقة أقدم وأكثر ترسخاً، هي القادرية.
غير أن القادرية اقتصرت على المدن، فلم تمتد إلى الريف الكردي، حيث غالبية الأكراد. كما أنها ظلت مرتبطة بالدولة العثمانية وجزء من "جهازها الأيديولوجي". على العكس، اتجهت النقشبندية إلى الريف ومناطق القبائل، فكانت مشيخاتها في بلدات صغيرة وأصعب على الضبط والمراقبة من طرف الدولة مثل مشيخة نهري ومشيخة بارزان. تبنت وصاغت النقشبندية مطالب واحتجاجات الكرد، وخاصة الفقراء منهم في مواجهة الإقطاع، كما قدمت لهم نظاماً أخلاقياً وتهذيبياً في فترة التيه هذه. كذلك لعبت دوراً اجتماعياً مهماً ساعد على تجاوز الانقسامات الطبقية، فلاحين في مواجهة الأغوات أو رحّل في مواجهة المستقرين. وبهذا ساعدت على تشكيل شعب كردي عبر تجاوز الانقسامات الأفقية.
بهذا تكون النقشبندية في تلك المرحلة، قد قدمت قيادة سياسية وروحية للشعب الكردي يتماهى معها، كما قدمت أيضاً نظاماً أخلاقياً ينتظم حوله الشعب؛ أي كل العوامل الأساسية للوعي القومي. بالمقابل عابت النقشبندية مسائل مهمة، فتمركزها حول الإسلام السني وتطرفها فيه وفي مواجهة الآخرين، سواء الأديان غير الإسلامية مثل الأيزيدية (بالمقابل كانت أكثر تسامحاً مع المسيحيين وإن ليس دوماً، ودخلت مواجهات عديدة مع الأرمن لكونهم خطر قومي) أو الفرق الإسلامية غير السنية (العلويون والشيعة الأكراد) وهو ما شكل عائقاً أمام توسيع الشعب الكردي ليتجاوز انقساماته العمودية كما فعلت مع انقساماته الطبقية.
لاحقاً بعد هزيمة الثورات التي قادتها النقشبندية، ومع انهيار الدولة العثمانية ونشوء الجمهورية التركية (بالترافق مع هزيمة آخر ثورة للنقشبندية - ثورة الشيخ سعيد بيران) تحولت النقشبندية إلى ذراع من أذرع الدولة في مواجهة القومية الكردية، وانقلب الدور الذي لعبته إلى عكسه تماماً. هذه العملية تمت عبر تحطيم المشيخات التقليدية وإضعافها وانتقالها إلى أطراف كردستان الغربية، ولاحقاً إلى المدن الكبيرة مثل إسطنبول، بما سهل للدولة التحكم بها واختراقها. أيضا التفت النقشبندية في حرب الاستقلال حول شعارات إسلامية سواء لحماية الخلافة أو الإسلام، وبهذا تماهت أكثر مع شعار "كلنا مسلمون".
هنا يمكن الحديث عن انقسام داخل القومية الكردية (أو التعبيرات السياسية للأكراد) بين قومية برجوازية بدأت تظهر وتأخذ دوراً أكبر داخل المدن وهوية إسلامية. في السنوات السابقة - حيث تولت النقشبندية قيادة المجتمع الكردي- لم يكن هناك تصادم بين سياسات القومية الكردية والسياسات المستندة على الإسلام. فمواجهة الإصلاح العثماني مكنت من المزاوجة بين الاثنين، وحتى القبول بالدولة العثمانية أو الخلافة سمحت بمثل هذه المزاوجة. لاحقاً -وخاصة مع التحول الذي أصاب الدولة العثمانية بتولي الاتحاد والترقي، ومن ثم انهيار الدولة ونشوء الجمهورية- أصبحت السياستان متناقضتين والمزاوجة بينهما غير ممكنة، وهكذا يكون الشقاق بين شعاري "كردستان للكرد" و "كلنا مسلمون" قد اكتمل، واكتمل معه انتقال النقشبندية إلى خندق الشعار الثاني، في حين سيتولى حزب العمال الكردستاني مسؤولية السياسات المرتبطة بالشعار الأول.
الميزة الأساسية للكتاب، هي لفت الانتباه إلى الفترة التي تولت فيها النقشبندية رعاية وتطوير القومية الكردية. فالنظرة الشائعة، سواء للأكراد أو للعرب تجاه النزاع بين التيارين القومي والديني، هي أن التيارين طالما كانا على طرفي نقيض، وأن التعبيرات القومية هي مضادة في طبيعتها للتعبيرات الدينية والعكس صحيح. أن تكون عربياً كانت على تضاد مع أن تكون مسلماً والعكس صحيح.
هذه النظرة عموماً هي نتيجة للخبرة التاريخية المتأخرة، منذ النصف الثاني من القرن العشرين وتحول سياسات القومية وسياسات الهوية الدينية إلى أيديولوجيات مكتملة ومتمايزة تفصل بينها حدود صلبة. عربياً، عراقياً وسورياً، يمكن التفكير بمسائل مشابهة. فمع تشييع القبائل العربية في جنوب العراق، لعب الشيوخ الشيعة في المدن-المزارات دوراً مشابهاً للدور الذي لعبته مشايخ النقشبندية، فهم قدموا مرجعية سياسية وروحية في فترة انحلال النظام العشائري وضعف وجود القانون وحكمه، حيث كان الحكم المركزي ضعيفاً، والقانون نادر في تلك المناطق. حاجج اسحق نقاش أن التطور الطبيعي لجنوب العراق كان سينتهي إلى دولة عربية شيعية، وأن هذا التطور قطعه الاحتلال البريطاني للمنطقة وربطها مع جنوب كردستان والموصل والمناطق السنية لإنشاء دولة العراق.
وهنا حدث تحول في دور ومكانة التشيع والمرجعيات الشيعية، التي قادت الثورات في مواجهة البريطانيين وقبلت بفيصل، لتصبح معضلة دائمة للدولة العراقية والوطنية العراقية بتطوير مرجعية موحدة (يفترض أن تكون الدولة). هنا سياسات القومية والدين ظهرتا في شكل مغاير لتجربة الجمهورية التركية، التي استعملت المشايخ ضد القومية الكردية، في الحالة العراقية كان مشايخ الشيعة ضد الدولة التي تبنت سياسات القومية العربية.
في سوريا كان هناك بعض الاختلافات من البداية، سوريا أكثر تمدناً من العراق وكردستان، الدولة أكثر حضوراً، تاريخ أطول من التعليم والمدارس سواء مدارس البعثات أو حتى مدارس الدولة. لهذا كانت الوطنية السورية/العربية أكثر علمانية من البداية، وأقل ارتباطاً بسياسات الدين، لكن أيضاً ليس تماماً. مثلاً لعبت حركة الإصلاح الديني (السلفية الشامية الأولى) دوراً مهماً في ترسيخ الجانب الوطني العربي، وحتى في مداورة الانقسامات الطائفية. بل من الطريف أن الجيل الأصغر من عائلات المصلحين سيلتحقون لاحقاً بالحركات القومية العلمانية، مثل أقرباء الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين القاسمي.
في فترة المملكة السورية القصيرة وخلال التحضير لمواجهة الفرنسيين، لعب المشايخ التقليديين (مثل علي الدقر وغيره الذين سيكونون لاحقاً ممهدين للعمل الإسلامي الذين ستكون ذروته تأسيس الإخوان المسلمين) دوراً مهماً في حركة الاستقلال والتحضير لمقاومة الفرنسيين، والتأكيد على شعار استقلال سوريا ووحدتها، في توافق عالٍ مع الجناح العلماني من الحركة الوطنية. كان علينا الانتظار لسنوات ليبدأ التنابذ والانفصال بين الاثنين، وتحول سياسات الهوية الدينية إلى عقبة في تشكيل الشعب بما يتجاوز انقساماته الطائفية، وفي النهاية إلى هوية مضادة للوطنية. أيضا من الطرائف، أن بيان الطليعة المقاتلة الأولى والخاصة بالثورة الإسلامية في سوريا أحيل مباشرة إلى الشيخ جمال الدين القاسمي، ولكن هذه المرة من موقع المقارعة الطائفية. ...
بكل الأحوال، يمكن الاستنئناس بالكتاب في تناول العلاقة بين سياسات الوطنية/القومية وسياسات الهوية الدينية، وكيف أن العلاقة بينهما لم تكن دوماً علاقة تناقض وتضاد، بل كانت في فترة مهمة في البداية (الإصلاح العثماني وظهور سياسات الجمهور) علاقة تكامل وتدعيم. الفصل سيحصل لاحقاً. وهنا يفيدنا الكتاب في تذكيرنا بهذه المسألة ولا نكتفي بالإطلال على التاريخ بأعين الحاضر. - المصدر:
نقلاً عن صفحة الكاتب موريس عايق على فيسبوك.





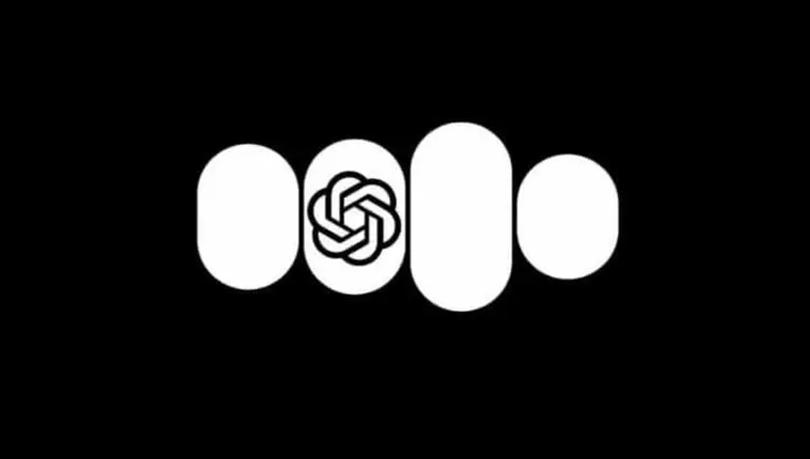




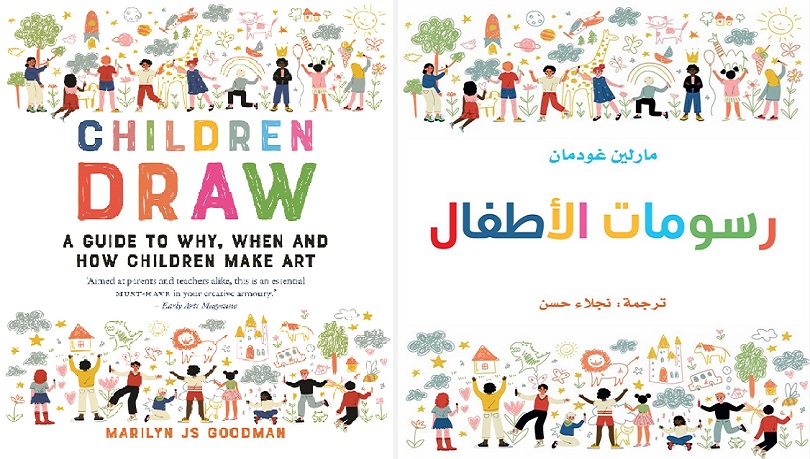





0 تعليقات